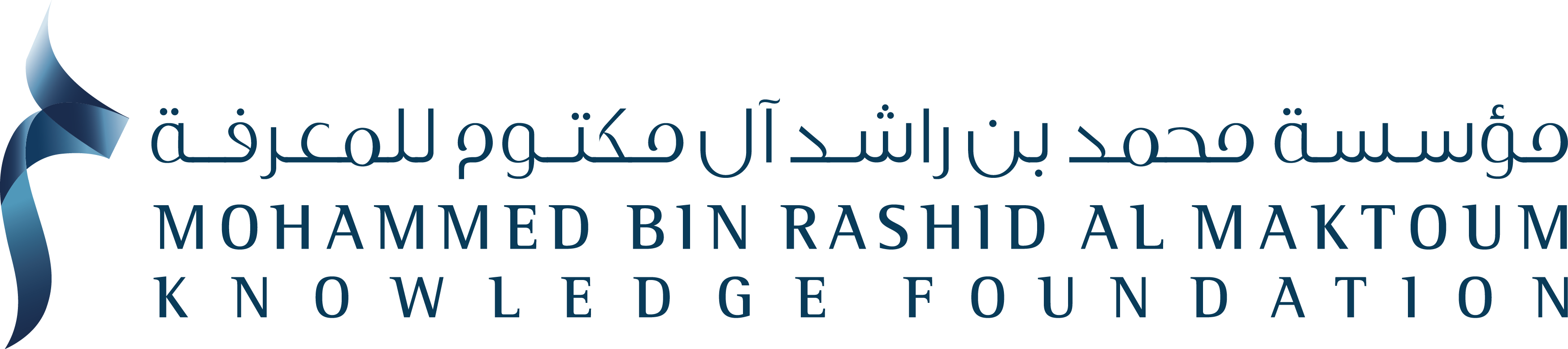الكتاب هبة الحضارة العربية للإنسانية
عنوان الازدهار وسر النهضة والعمران وبوابة ولوج ميدان الازدهار العلمي
عندما تتمايز الحضارات فيما بينها بميزة تنفرد بها عن سواها وتكون عنواناً لها، سوف نجد على سبيل المثال أنَّ عنوان الحضارة المصرية القديمة هو: الآثار الحجرية متمثلة في الأهرامات والتماثيل والمعابد، وسوف نجد أيضاً أنَّ عنوان الحضارة الإغريقية؛ الفلسفة والمنطق، وعندما نأتي إلى الحضارة العربية الإسامية لا نجد عنواناً لها سوى «الكتاب».
وقد يستغرب بعضنا من أن يكون الكتاب عنواناً لأمة قد اشتهرت في التاريخ القديم بأنها أمة غير كاتبة، غير أننا إذا تأملنا في حقيقة الأمر فسوف نجد أنَّ الكتاب منذ بداية فجر الإسلام هو توجيه قرآني من الله عزّ وجل، إذ إنَّ أول آية كريمة كانت اقرأ كما أنَّ السنّة النبوية الشريفة سارت على هذا النهج القويم من الحث على العلم وطلبه، فقد حرص الرسول منذ البداية على العلم والتعليم ففرض على كل أسير من أسرى المشركين في غزوة بدر يجيد القراءة والكتابة أن يفدي نفسه مقابل أن يعلّم عشرة من أبناء المسلمين.
والقراءة، كما هو معروف، وسيلة إلى العلم عبر وسيلة أخرى وهي «الكتاب » فلا علم بلا كتاب، وبالطبع لا قراءة بلا كتاب؛ فالعلم هنا هو الغاية، والكتاب هو الوسيلة. وإذا كانت الحضارة العربية الإسلامية الحضارة الأبرز في ميدان التقدم العلمي والتي استمرت ما يقرب من ثمانية قرون، وهو زمن ليس بالقليل في عمر الحضارات، ووسع ملكها من الأندلس غرباً إلى تخوم الصين شرقاً، وكل هذا يؤكِّد أنَّ أصدق عنوان للحضارة العربية الإسلامية هو «الكتاب » الذي هو وعاء المعرفة على اتساع أنماط المعرفة ولاسيما «العلم » بالمعنى الذي تدل عليه كلمة Science وهو عامل تقدم الأمم ونهضتها ورقيها.
وعندما ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية، إنما كانت بفضل ما وصلت إليه من تقدم علمي كان بفضل إبداع العلماء العرب في مجال سائر العلوم كالطب والفلك والجغرافيا والرياضيات... بعد أن استوعبوا ما يسمّى في أدبيات التراث «علوم الأوائل » من تراث اليونان والفرس والهنود، وأخذوا ما هو مقبول وصحيح علمياً، ونقدوا ما هو خطأ أو خرافة أو ما هو غير مقبول عقلاً ومنطقاً في هذا التراث، وإن كان العلماء العرب قد أوردوا في مؤلفاتهم كثيراً من تلك الآراء منسوبة إلى أصحابها من أساطين اليونان أو الفرس والهنود، فإنما أوردوها ليس من قبيل الإيمان بها أو الموافقة عليها، وإنما هي نوع من الأمانة العلمية التي درج عليها العلماء العرب كأثر من آثار علوم الحديث من إثبات رجال السند والرواة عبر العنعنات الكثيرة في كتب الحديث وغير كتب الحديث أيضاً.
ومن هنا فإنَّ التراث الإنساني أو «علوم الأوائل » قد خضع لأكبر عملية للترجمة إلى العربية قام بها الخلفاء في العصر العباسي على نحو معروف ومشهور ولاسيما الخليفة المأمون الذي كان يعطي زنة ما يترجم من الذهب مثلاً بمثل حتى كاد بيت المال يفلس. وتروي لنا كتب التاريخ أقاصيص شتى أنَّ الخلفاء العباسيين لم يدخروا وسعاً في شراء وجلب الكتب اليونانية، وأنفقوا أموالاً طائلة على النقلة، وأجروا عليهم الأرزاق.
يقول ابن النديم: «كان بين المأمون وبين ملوك الروم مراسلات، فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما يختاره من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم، فأجاب عن ذلك بعد امتناع، فأخرج المأمون جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة، فاختاروا مما وجدوا وأخذوه، فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنُقِل.
ومعنى هذا أنَّ التراث الإنساني كله وبالأخص التراث اليوناني، أصبح في متناول العلماء العرب، وقد بادر العلماء العرب بعد ذلك بالقيام بالخطوة المنطقية التالية؛ أي التأليف ولكن في سياق مبتكر وغير مسبوق في أغلب الأحيان بعدما أدركوا الكثير من نقاط الضعف، ومن الأخطاء العلمية الواردة في مؤلفات التراث اليوناني، فألّف العلماء العرب كتباً نقدية تفنِّد أخطاء أساطين علماء وفلاسفة اليونان مثل كتاب ابن الهيثم «الشكوك على بطليموس » وكتاب الرازي «الشكوك على جالينوس »، فضلاً عن أن معظم مؤلفات العرب في شتى المجالات قد تعرَّضت لأخطاء اليونان في مؤلفاتهم.
ولعلَّ أشهر من تصدَّى لأخطاء جالينوس هو ابن النفيس الذي توصَّل إلى واحد من أشهر الكشوف العلمية وهو اكتشاف الدورة الدموية، على النحو الذي فصَّلته المستشرقة الألمانية زجريد هونكه Z. Honke في فصل خصَّصته لهذا الكشف. وبذلك يكون العلماء العرب هم أول من وضعوا أسس النقد العلمي كعلم مستقل بذاته في تاريخ العلم، وهو ما تجاهله المستشرقون ومؤرخو العلم.
مؤلفات التراث العلمي العربي
لم يألُ المستشرقون جهداً في الطعن على العلم العربي لحساب العلم اليوناني حتى إنَّ زجريد هونكه قد استنكرت ما يروج لدى كثير من المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين أنَّ العرب ليس لهم دور في التاريخ الإنساني سوى أنهم «قد لعبوا دور ساعي البريد عندما نقلوا كنوز قدامى اليونان إلى الغرب ».
ومن غلاة المستشرقين وعلى سبيل المثال فإنَّ المستشرق الفرنسي كارا دو فو Carra de Vaux لا يتوانى عن الطعن الصريح في العرب حيث يقول: «لا ينبغي أن نتوقَّع أن نجد لدى العرب تلك العبقرية الخارقة، وتلك الموهبة المتمثلة في المخيلة العلمية، وذلك الحماس، وذلك الابتكار في الفكر، مما نعرفه عن الإغريق. فالعرب قبل كل شيء إنما كانوا تلاميذ للإغريق، وما علومهم إلا استمرار لعلوم اليونان التي حافظوا عليها ورعوها، وفي بعض الحالات طوروها وحسنوها.
غير أنَّ كثيراً من مؤلفات التراث العلمي كان لها شأن آخر في تاريخ العلم؛ ففي الطب باعتراف عدد من المستشرقين الذين توافروا على البحث في التراث العلمي العربي، يقول مونتجومري وات M.Watt في كتابه «فضل الإسلام على الحضارة الأوروبية» : « وبلغ العديدون من المسلمين شأواً بعيداً في الإلمام بعلم الطب، لدرجة أنهم بزوا أسلافهم بمراحل. وإنما تحقَّق لهم هذا إذ جمعوا بين المعرفة النظرية الواسعة والمران العملي الذي دوَّنوا أثناءه الملاحظات الثاقبة الدقيقة».
استوعب علماء العرب علوم
الأوائل وأخذوا ما هو مقبول
وصحيح علمي ونقدوا ما هو
خطأ أو خرافة
ويكفي أن نشير هنا إلى أشهر طبيبين: وهما الرازي وابن سينا، فلا يزال للرازي (توفي بين عامي 923 و 932) أكثر من خمسين مؤلفاً له بين أيدينا، من أفضلها رسالة في الجدري والحصبة، ترجمت إلى اللاتينية واليونانية والفرنسية والإنجليزية. وأعظم كتبه هو كتاب «الحاوي » الذي كان موسوعةً لكلِّ المعارف الطبية حتى زمنه. وقد عرض بصدد كل مرض آراء المؤلفين اليونانيين والشاميين والهنود والفرس والعرب، مضيفاً ملاحظاته من خلال تجاربه العملية، ومعبراً في الختام عن وجهة نظره.
وفي الفلك يقول ديورانت: «W.Durant» عن بعض فلكيي العرب: «ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئاً إلا بعد أن تثبته الخبرة والتجارب العملية، وكانوا يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية خالصة، وكتب الفرغاني (نحو عام 860 م) كتاباً في الفلك ظلَّ مرجعاً تعتمد عليه أوروبا وغربي آسيا سبعمائة عام. وأوسع منه شهرة البتاني الذي ظلَّ واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشتهرت بدقتها واتساع مداها، وقد وصل بهذه الأرصاد إلى كثير من المعاملات الفلكية التي تمتاز بقربها العجيب من تقديرات هذه الأيام. ومنهم أبو الوفا البوزجاني، الذي كان يعمل تحت رعاية سلاطين بني بويه الأولين حكّام بغداد، والذي كشف الانحراف الثالث للقمر قبل تيخو براهي Tycho Brahe بستمائة عام.
ويقول ماكس مايرهوف متحدثاً عن كتاب «البصريات » للحسن بن الهيثم: «إن روجر بيكون وكل كتّاب القرون الوسطى في البصريات وبالأخص ويتلو Witlo الهولندي بنوا أبحاثهم البصرية على كتاب البصريات لابن الهيثم بصورة رئيسة، لذلك بقي منهلاً ليوناردو دا افنشي L.da Vinci ويوهان كبلر J.Kepler ».
أمّا في الرياضيات فكان لها شأن آخر يلخصه لنا مؤرخ الرياضيات جون ماكليش J. Mclish في كتابه «العدد » بقوله: «حدثت الإنجازات العربية الرئيسة في العلوم والرياضيات أثناء العصور الذهبية للتفوُّق الإسلامي. وقد حفظ برنامجهم الضخم لترجمة الأعمال العلمية إلى العربية من اللغات البابلية والمصرية واليونانية والهندية والصينية، فأصبح متاحاً لعلماء الغربيين. وكان هذا أساس الثورة العلمية الغربية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر».
كذلك فإنَّ العرب قد أبدعوا فروعاً جديدة في الرياضيات، نذكر منها الجبر وحساب المثلثات، كما أنهم وضعوا أسس الهندسة التحليلية. ووضع العرب قبل نابيير بستمائة سنة الأفكار الرئيسة التي تستند إليها اللوغاريتمات. أمّا في أوروبا المسيحية فلقد كان تقليداً طوال ما يقرب من أربعة قرون من الزمن تشويه سمعة المساهمة العربية في الرياضيات. إنَّ تألق الرياضيات اليونانية كان حكراً على عدد صغير من المفكرين الذين طوَّروا الهندسة وجعلوا منها فرعاً منطقياً استنتاجياً، إنما أخفقوا تماماً في الوصول إلى ترميز عددي مناسب.
لذلك فإنَّ المقارنة الحقّة للرياضيات العربية لا تكون باليونان القدماء، بل بأوروبا خلال القرون الممتدة من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر. والأوروبيون الذين تميزوا في الرياضيات كانوا طلاباً في معاهد العلم العربية. وقد استرعى هذا الحماس الشديد من قِبل العرب ما بين الترجمة والتأليف وما صاحب التأليف من ابتكار وإبداع، نظر فريق من مؤرخي العلم فعدَّ صنيع العرب خروجاً على سياق التطوُّر الطبيعي في الأمور؛ يقول جوستاف لو بون J.Le.Bon: « والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، وإذا كانت هناك أمم تستوي هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل ».
وحول هذا المعنى يقول جولدشتين Goldstein: « الإسلام هو واحد من أشد الظواهر إدهاشاً في التاريخ الثقافي، ففي ما بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن صعدت القبائل البدوية لشبه الجزيرة العربية ورفعوا أنفسهم من مستوى البدو إلى مستوى الورثة اللامعين للثقافات القديمة؛ بسبب الحماس الفطري لقوم لم تفسدهم الحضارة إلى حد كبير يتحرقون لاستيعاب الميراث الثقافي الذي كان منبسطاً أمام أعينهم في البلاد المفتوحة».
لقد آثرنا أن نقدم هذه الأقوال من شهادة نفر من المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين، حتى تكون الشهادة من أهلها، وحتى يكون قول الغير هو الأقرب للحقيقة والصدق.
هبة العرب للحضارة الإنسانية
كان هذا هو حال التراث العلمي العربي الذي حوى ضمن ما حوى تراث الأوائل من يونان وفرس وهنود، أي إننا أمام التراث الإنساني كله عبر تاريخه الطويل بعدما نقحه وهذَّبه وشرح غوامضه العلماء العرب، كل هذا التراث قد وجد طريقه إلى الأندلس وهي أهم معابر الثقافة العربية إلى أوروبا، وبالتالي صار في أيدي الغرب بعد زوال الدولة الأموية في الأندلس، وسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين فيها بعد ما عرف في أدبيات التاريخ الأوروبي ب «حرب الاسترداد » مما هو معروف ومشهور ومسجل في كتب التاريخ.
وقد خضع هذا التراث إلى أطول فترة للترجمة في التاريخ وذلك من العربية إلى اللاتينية، فقد بدأت الترجمة على أساس منظم على يد قسطنطين الإفريقي (المتوفى سنة 1087 م) - أي في النصف الأول من القرن الحادي عشر- الذي ترجم كثيراً من المؤلفات الطبية من العربية إلى اللاتينية، وفي غضون النصف الثاني من القرن الرابع عشر بلغت اللاتينية حداً صارت المترجمات لا تنقل إليها فقط، بل تنقل منها وبكميات واسعة، وكان تيار الترجمة من العربية إلى اللاتينية الجبار قد أوشك على الجفاف.
تصدَّى ابن النفيس لأخطاء
جالينوس وتوصَّل إلى واحد
من أشهر الكشوف العلمية
وبعيداً عن سرد وضع المكتبات العامة، ومكتبات الأفراد في حواضر الأندلس، مما نجده مذكوراً في مؤلفات كلِّ من أرَّخ لحكام وولاة الأندلس، إلا أننا سوف نذكر حاكماً واحداً فقط من حكام ولايات الأندلس وهو الأمير المستنصر الحكم بالله (المتوفى سنة 366 ه/ 976 م) الذي أقام للعلم والعلماء سوقاً، جلبت بضائعه من كل قطر، وكان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده، حتى قيل إنها كانت أربعمائة ألف مجلد، وإنه استجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق من عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغريبة من العلوم القديمة والحديثة وجمع منها في أيام أبيه، ثمَّ في مدة ملكه من بعده ما يكاد ما يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة.
ويعلق المستشرق جاك ريسلر J.Ressler على هذا الأمر ساخراً بقوله: «وفي قرطبة كان الحاكم يملك مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب، بينما لم يكن ملك فرنسا شارل الخامس قادراً بعد ذلك بأربعة قرون على جمع أكثر من ألف كتاب». إذن فالتراث الإنساني كله الذي نقله العرب، إضافة إلى التراث العربي وما أبدعه العلماء العرب طوال ما يقرب من ثمانية قرون قد أصبح موجوداً بأكمله في حواضر ومكتبات الأندلس؛ أي إنه صار في متناول أيدي المترجمين الأوروبيين، وقد خلص أحد الباحثين الأسبان إلى أنَّ ما تركه العرب في الأندلس أكثر من مليوني كتاب.
فأي هبة عربية تلك التي وجدها الأوروبيون بين أيديهم؟! ولعلَّنا لا نجاوز الصواب إذا قلنا إنه لولا تلك الهبة العربية التي تمثِّل التراث الإنساني كله لبدأ الأوروبيون من حيث بدأ العرب، ولتأخر ظهور عصر النهضة قروناً عديدة باعتراف مؤرخي الغرب أنفسهم. ولم يكتف الأوروبيون بالترجمة فحسب بل تناولوا التراث العربي بالانتحال والسطو وادعاء التأليف، الأمر الذي كشفه فريق من المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين أنفسهم، وهذا مجال يطول الحديث فيه؛ فقد أثبتت الدراسات الحديثة التي أجراها عدد من مؤرخي العلم الذين توافروا على البحث في التراث العلمي العربي حالات السطو والانتحال وادعاء التأليف، وحول هذا الموضوع يقول فؤاد سيزكين: «اتخذت عملية أخذ اللاتينية من علوم العرب صفة الانتحال، ولقد بيَّن هذا عدد من العلماء المتخصصين في بحوث كثيرة كيف انتحلها علماء لاتينيون، في كتب العلماء العرب أو ترجموها إلى لغتهم، زاعمين أنها من إبداعهم وتأليفهم».
إنَّ الباحثين العرب في تاريخ العلم مطالبون بكشف الحقائق والخبايا التي غشّاها ستار صفيق من الصمت حول هذا الكم الكبير من السطو على الإبداع العلمي للعلماء العرب، حتى لا يقع النشء العربي فريسة الانبهار بتفوق الأوروبيين قديماً وحديثاً، وما يتبع ذلك من أثر نفسي غير محمود على الأجيال القادمة من بني العرب.
* كبير باحثين بهيئة المساحة الجيولوجية (سابقاً)