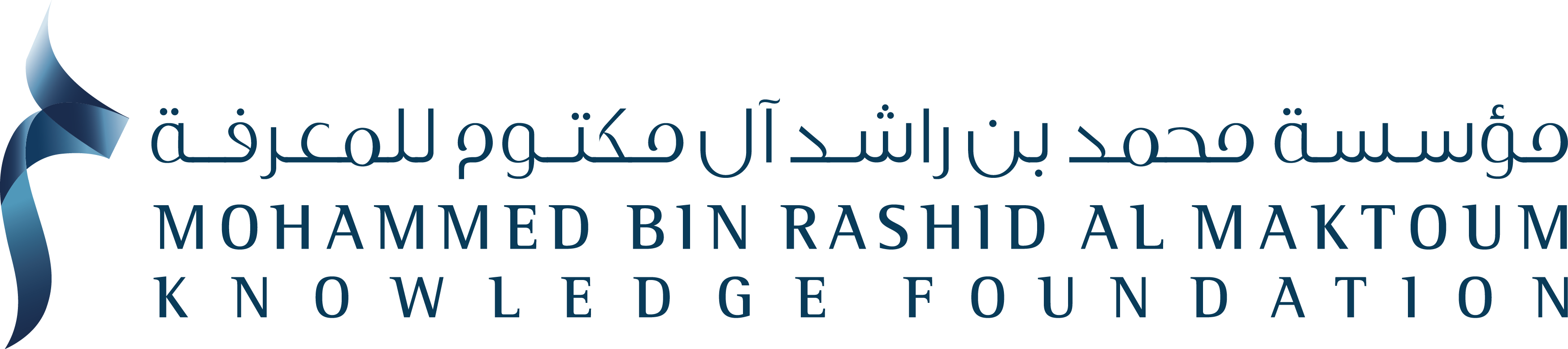ثغرات الأساس الاقتصادي للنظام العالمي
روبرت سكيدلسكي
تماماً كما يُـعَـد الإلحاح في طلب المزيد من «الشفافية» علامة أكيدة على زيادة الغموض والتعتيم، فإن الصخب الحالي بشأن «الفِـكر المشترك» يشير إلى أن الحاجة إليه تفوق بدرجة كبيرة المعروض منه. من خلال تقريرها الأخير عن أمن الطاقة، أضافت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس اللوردات في المملكة المتحدة صوتها إلى الجوقة.
جاءت لغة التقرير مُـقَـيَّـدة، لكن رسالته كانت واضحة: في غياب سياسة الطاقة التي تستند إلى «فِـكر مشترك»، سيكون انتقال المملكة المتحدة إلى صافي الانبعاثات الـصِـفري بحلول عام 2050 «فوضوياً» (أي أنه «لن يحدث»). على سبيل المثال، تتعارض السياسة الرامية إلى تحسين عزل المساكن مع لوائح البناء المطبقة من قِـبَـل السلطات المحلية.
في أبريل، دعت الحكومة بنك إنجلترا والهيئات التنظيمية المالية إلى «مراعاة» أمن الطاقة. تُـرى ماذا يعني هذا؟ أي المؤسسات مسؤولة عن أي أجزاء من أمن الطاقة؟ وكيف يرتبط أمن الطاقة بهدف صافي الانبعاثات الصِـفري؟ بصرف النظر عن الثغرات في البيانات: تكمن المشكلة الحقيقية في الانقسامات الواسعة في التفكير.
الواقع إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ساهمت بشكل كبير في اندلاع أزمة هائلة في الطاقة والغذاء تهدد البلدان التي فرضت العقوبات بالركود التضخمي فضلاً عن دفع عدد كبير من الناس في الاقتصادات النامية إلى المجاعة.
يخلص التقرير إلى أن المملكة المتحدة يجب أن «تمتنع عن الاعتماد على المنافسين الاستراتيجيين، وخاصة الصين، في الحصول على المعادن والمكونات الحرجة». علاوة على ذلك، «يتعين على الحكومة أن تعمل على ضمان توافق سياساتها الخارجية والتجارية مع سياسة صافي الانبعاثات الـصِـفري». الأمر يتطلب إذن المزيد من التفكير المشترك.
تعكس الثغرات المتزايدة الاتساع في تشكيل السياسات التقسيم المتزايد للعمل الناتج عن مسيرة التعقيد العنيدة. يعرف صناع السياسات ومستشاروهم اليوم المزيد والمزيد عن أقل القليل، وهم يذكروننا بوصف آدم سميث في كتابه «ثروة الأمم» لعمال مصنع الدبابيس:
«الرجل الذي أمضى حياته بالكامل في أداء عمليات بسيطة قليلة، والتي قد لا تتغير التأثيرات المترتبة عليها أبداً، أو تظل هي ذاتها تقريباً، ليس لديه أي فرصة لممارسة فهمه، أو ممارسة قدرته على الاختراع في إيجاد السبل لإزالة الصعوبات التي لا تأتي أبداً. من الطبيعي إذن أن يفقد عادة هذه الممارسات، ويصبح في عموم الأمر غبياً وجاهلاً بقدر ما يستطيع أن يصبح عليه كائناً بشرياً».
لن يحتاج أي شخص في مصنع سميث إلى معرفة كيفية صنع دبوس بالكامل، أو حتى ما الغرض من إنتاجه. لن يعرف إلا كيفية صنع جزء من الدبوس. على نحو مماثل، أصبح العالم عامراً بالخبراء الذين لا يعرفون سوى أجزاء ضئيلة عن موضوعهم.
لم يتمكن نموذج «إنسان النهضة» الذي كان بوسعه القيام بقدر كبير من التفكير المشترك من النجاة من تقسيم العمل المتزايد التعقيد. بحلول القرن الثامن عشر، أصبحت المعرفة منقسمة إلى «تخصصات». والآن، تنبت التخصصات الفرعية على نحو لا يمكن السيطرة عليه، وتُـترك عملية نقل نتائج هذه التخصصات إلى عامة الناس للصحافيين الذين لا يحيطون علماً بكل شيء.
الفجوة الأكبر على الإطلاق اليوم، والتي بلغت من الضخامة حداً يجعلها تُـنـذِر بكارثة، هي تلك التي نجدها بين العالَـم الجيوسياسي والاقتصاد. لم تعد وزارات الخارجية والخزانة تتحدث مع بعضها بعضاً. فكل من الفئتين تعيش في عالَـم مختلف، وتستخدم لغة نظرية مختلفة، وتفكر في مشاكل مختلفة.
ينقسم العالم الجيوسياسي إلى «شركاء استراتيجيين» و«منافسين استراتيجيين». ولا تزال الحدود بين الفئتين قائمة وقوية. تسعى الدول إلى تحقيق مصالح وطنية متضاربة وتلاحق سياسات الأمن الوطني. في المقابل، نجد أن الاقتصاد هو علم السوق الواحدة: إذ يتمثل هدفه الأمثل في إيجاد التكامل الاقتصادي عبر الحدود وآلية أسعار عالمية تعمل تلقائياً على التنسيق بين التفضيلات المتضاربة. تنبئنا علوم الاقتصاد أيضاً بأن التجارة تعمل على التخفيف من حِـدة السياسة، فتخلق بمرور الوقت مجتمعا واحداً للتعلم والثقافة.
الواقع أن مؤرخ القرن الثامن عشر الإنجليزي إدوارد جيبون وصف التاريخ بأنه «أكثر قليلاً من مجرد سجل للجرائم والحماقات ومصائب البشرية». لكن نهاية الحرب الباردة أدت إلى نشوء الأمل في نضوج العالم أخيراً؛ في عام 1989، أعلن الأكاديمي الأميركي فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ».
ولكن اليوم، عادت العوامل الجيوسياسية إلى المعادلة. وتصر الحكومات الغربية على الحاجة إلى التعاون العالمي في التصدي لتغير المناخ الذي من المحتمل أن يكون مُـهلِكا وغير ذلك من المخاطر الوجودية مثل الانتشار النووي وتفشي الأوبئة والجوائح الـمَـرَضية.
إنها لمأساة أن يتعرض الأساس الاقتصادي الذي يقوم عليه النظام العالمي اليوم، على حاله، للخطر على هذا النحو. يرجع منشأ هذا الخطر إلى تصرفات تتقاسم القوى العظمى المسؤولية عنها. العجيب في الأمر أن المؤسسة التي تحمل على نحو لا يخلو من مفارقة مسمى «الأمم المتحدة»، والتي وجدت لتحقيق الأمن الكوكبي، أصبحت مهمشة تماماً. وغيابها الفعلي عن المشاهد الكبرى في الصراع الدولي هو الثغرة الأكبر على الإطلاق، الثغرة التي تهدد مستقبلنا المشترك بخطر مُـهلِـك.