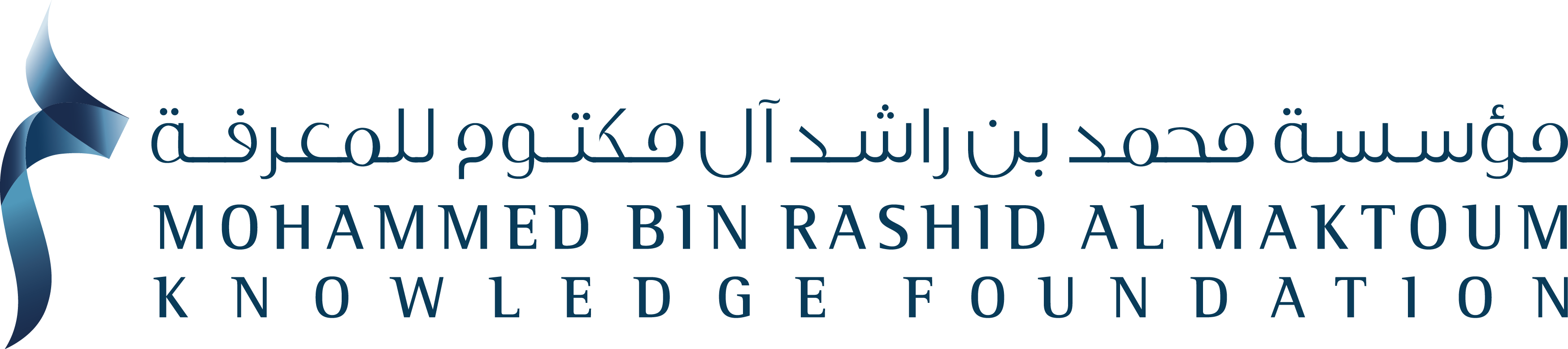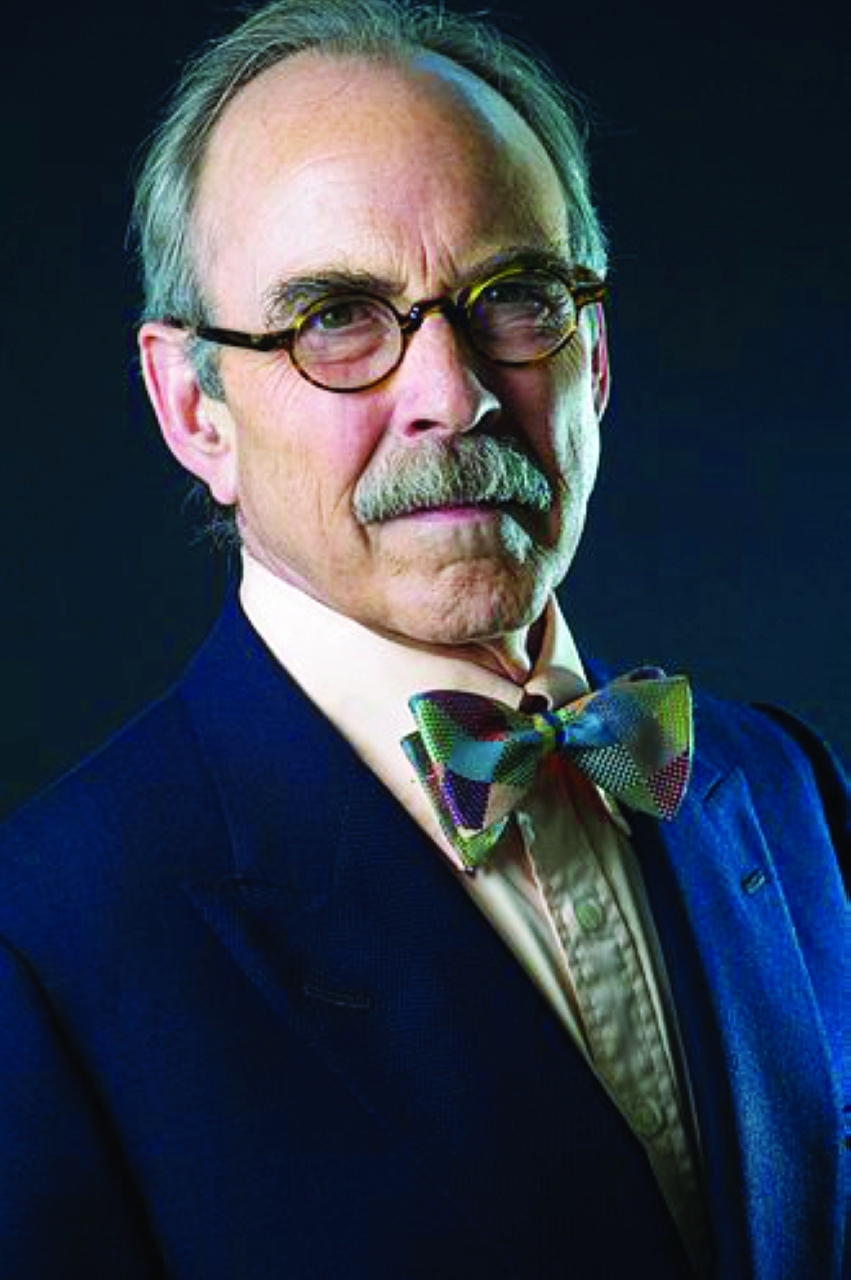صعود وسقوط المؤسسة التجارية النافعة اجتماعياً
المصدر: ويليام ه. جانواي
في كتابه الجديد «المسيرة المتخاذلة نحو المدينة الفاضلة»، يشير الخبير الاقتصادي جيه. برادفورد ديلونج إلى أن «مختبرات البحوث الصناعية والمؤسسة التجارية الحديثة» كانت المفتاح إلى إطلاق العنان لزيادة جذرية في معدل الإبداع العملي والتكنولوجي، وبالتالي النمو الاقتصادي، بداية من عام 1870 فصاعداً. وهو محق في ذلك. كما اعـتَـبَـر ديلونج معاهدة ديترويت، وهي التسوية البارزة في عام 1950 بين شركة جنرال موتورز ونقابة «عمال السيارات المتحدون»، ركيزة أساسية للديمقراطية الاجتماعية على النمط الأمريكي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن ماذا حدث للشركات العملاقة التي فتحت الباب لعقود من الزمن من النمو في حين عملت على رعاية التأمين الصحي ومعاشات التقاعد لموظفيها؟
مع حلول الاكتشاف العلمي محل أعمال السمكرة الميكانيكية كأساس للإبداع الحقيقي في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الشركات التي تولدت عن الثورة الصناعية الثانية (الصلب، والسكك الحديدية، والإنتاج الضخم) هي التي وفرت التمويل اللازم للبحوث. كتب ديفيد مويري وناثان روزنبرج في كتابهما المشترك بعنوان «التكنولوجيا والسعي وراء النمو الاقتصادي»، «في شركات مثل شركة التليفون والتلغراف الأمريكية، أو جنرال إلكتريك، أو الأمريكية للصلب، أو DuPont، كان تطوير مكتب مركزي قوي مرتبطاً بشكل وثيق بتأسيس منشآت بحثية مركزية أو توسعها بشكل كبير».
من خلال تخصيص أرباحها الاحتكارية للبحث العلمي وتطوير التطبيقات التكنولوجية، وسعت هذه الشركات قوتها السوقية في حين خدمت أيضاً غرضاً اجتماعياً أكبر.
لكن في غضون جيل واحد، خضعت الأرباح الاحتكارية المتاحة لتمويل مشاريع البحث والتطوير والمنافع الاجتماعية لضغوط متنامية، واستسلمت شركات التكنولوجيا العظيمة من حقبة الحرب العالمية الثانية الواحدة تلو الأخرى لقوى التدمير الـخَـلّاق التي تحدث عنها شومبتر فضلاً عن فرض قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.
كانت شركات مثل AT&T وIBM من الأهداف المتكررة لقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، لكن من المهم أن نشير هنا إلى أن كل حالة من حالات تدخل الدولة أثبتت كونها مفيدة بشكل مباشر للمشروع الأوسع للإبداع الأمريكي.
فشلت شركات عملاقة أخرى من تلقاء ذاتها. فقد دُهِـسَـت شركة الأمريكية للصلب من قِـبَـل مجموعة من المنتجين الأجانب الأكثر كفاءة فضلاً عن ظهور «المصانع الصغيرة» المحلية التي ازدهرت على الخردة المعدنية.
حتى مع انسحاب شركات القطاع الخاص الكبرى في القرن العشرين من الحدود العلمية والتكنولوجية، عوضت عن غيابها وزيادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية، التي أصبحت الممول الرئيسي لمشاريع البحث والتطوير. ومع امتداد جذورها إلى مكتب البحث العلمي والتطوير من زمن الحرب العالمية الثانية، عملت وزارة الدفاع على تمويل التطوير عبر جميع التكنولوجيات التي شكلت في مجموعها الثورة الرقمية ــ من وادي السليكون إلى البرمجيات. وبغرض استغلال الفرص التجارية التي أتاحتها المنتجات النهائية، نشأت صناعة رأس المال الاستثماري المحترف، أولاً لتمويل الإبداع الرقمي، ثم لإطلاق الشركات البادئة في مجال التكنولوجيا الحيوية بعد «الحرب على السرطان» التي شنها الرئيس ريتشارد نيكسون.
لكن الدور الذي اضطلعت به الشركات الكبرى في توفير الرعاية الاجتماعية لموظفيها لم يعوض عنه أحد بعد تراجعها. الأسوأ من ذلك أن قانون تافت-هارتلي لعام 1947 فتح الباب أمام قوانين «الحق في العمل» على مستوى الدولة والتي أثبتت فعاليتها العالية في تقليص العضوية في النقابات في القطاع الخاص على مدار عقود ما بعد الحرب.
أثناء الحقبة النيوليبرالية التي بلغت منتهاها الآن، نشأ هدف جديد للفرصة لتوظيف التدفق النقدي الفائض في هيئة عمليات إعادة شراء أسهم الشركات. في السابق، كانت الهيئات التنظيمية تحظر هذه الممارسة باعتبارها شكلاً من أشكال التلاعب بالسوق. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات غيرت القاعدة في عام 1982. الآن نجد أن أكثر من 60% من الشركات الأمريكية تعيد شراء أسهمها كل عام، وتتجاوز المبالغ السنوية لهذه المشتريات عادة مدفوعات الأرباح النقدية.
تزامن صعود النظام النيوليبرالي، الذي جرى توثيقه وتحليله بغزارة في كتاب حديث من تأليف جاري جيرستل من جامعة كمبريدج، مع زوال المؤسسة التجارية النافعة اجتماعياً. اليوم أصبحت شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة غير متحمسة وغير مجهزة للاضطلاع بهذا الدور، وهذا أحد الأسباب وراء كفاحها لنيل الشرعية. بالنظر إلى المستقبل، أستطيع أن أتنبأ بأن الاستثمار المعزز في الدينامية التكنولوجية والرفاهية الاجتماعية، تحت الضغوط التي يفرضها تغير المناخ، ستأتي في الأغلب الأعم من القطاع العام، إن وُجِـد. تُـرى هل يتمكن قانون الشرائح والعلوم الأمريكي وقانون خفض التضخم من إطلاق العنان لعصر جديد من الإبداع؟ بوسعنا أن نأمل ذلك، لكن الأمل ليس فعلاً مبنياً لمعلوم.