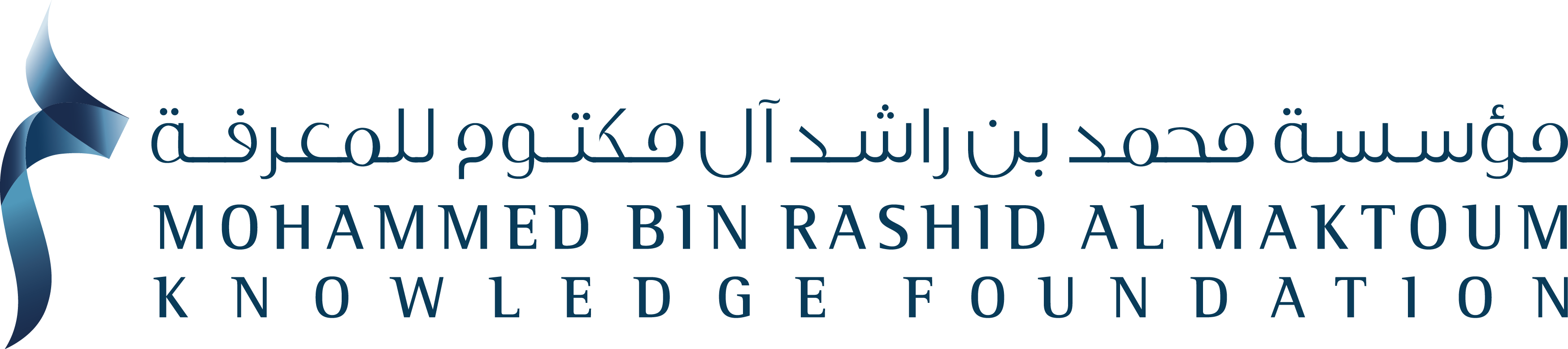النساء وجدارتهن في قيادة مبادرات حماية البيئة والمناخ
مينا سلامي *
لخصت مشاحنة تفجرت أخيراً على موقع «تويتر» بين أندرو تيت، أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وغريتا تونبيرغ، الناشطة في مجال المناخ، ففي تغريدة وجهها قصداً إلى الناشطة، تفاخر تيت، الذي يعد مثالاً صارخاً لرجل يرى في إنقاذ الكوكب تهديداً له كرجل، «بالانبعاثات الهائلة» التي تصدرها مجموعة سياراته الفارهة، فما كان من غريتا إلا أن أفحمته بردٍّ ساحق موجع يحتل حالياً المرتبة الرابعة بين أكثر التغريدات حصداً للإعجاب على الإطلاق. وعلى حد قول كاتبة العمود ريبيكا سولنيت: «هناك ارتباط مباشر بين الهيمنة من قبل غالبية من الرجال ورفض الاعتراف بالكارثة المناخية والاستجابة لها كما ينبغي».
ربما قلل بعض الناس من شأن تلاسن عبر الإنترنت بين شخصيتين شهيرتين، غير أن التباينات في كيفية استجابة النساء والرجال لظاهرة الانحباس الحراري في العالم حقيقة موثقة جيداً، فقد أظهرت دراسات حديثة أن نسبة الملتزمين بنمط حياة مراعٍ للبيئة بين الرجال في بريطانيا لا تتجاوز 59 %، بينما تصل النسبة إلى 71 % بين النساء، وأن اهتمام الرجال بإعادة التدوير واستهلاك منتجات مراعية للبيئة أقل احتمالاً من النساء، وعُزيت هذه الفجوة إلى نظرة بعض الرجال إلى العدالة البيئية على أنها مسعى نسائي.
مع تسبب تلوث الهواء الناجم عن أنواع الوقود الأحفوري في قتل الملايين من الناس كل عام (يسكن معظمهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية)، تشكَّل لدينا التزام أخلاقي واضح بمكافحة تغيّر المناخ، ونظراً للضرر الذي يُلحقه التحيز الجنساني بالقدرة على التحرك بشكل عقلاني في هذا الصدد، ينبغي لنا توضيح العلاقة المدرَكة بين تغيّر المناخ والآراء الجنسانية المقولبة والعقلانية، والعمل على تغييرها.
شأن كل الفجوات الجنسانية، جاءت هذه الفجوة نتاجاً لتفكير خادع ومتحيز، أي النقيض التام للعقلانية. إن هذا النوع من التفكير، وليس العاطفة، هو ما يقوض العقل، فالعواطف تجعلنا إنسانيين لا غير عقلانيين، لكن التحيز، مهما كان سببه، هو ما يجعلنا عاجزين عن التحلي بالموضوعية، لكن من النقاط التي قلما يتطرق إليها أحد كيفية اعتماد النظرة المقولبة على فكرة العقلانية، التي هي محدودة في الأساس.
لا تقتصر العقلانية في مفهومها على «القدرة على استخدام المعرفة لإحراز الأهداف»، كما يرى عالم النفس المعرفي والتطوري ستيفن بينكر في كتابه «العقلانية: ما هي؟ ولماذا تبدو نادرة؟ ولماذا هي ضرورية؟». كما أنها ليست مجرد مفهوم فلسفي يعني الخضوع للتدقيقات المنطقية والميتافيزيقية، فقد أضحت العقلانية أيضاً إطاراً أخلاقياً جامعاً ذا دلالات اجتماعية وسياسية عميقة. إن فهمنا للعقلانية قادر على التأثير في الاستراتيجية السياسية، وصياغة قوالب السياسات، وتشكيل علاقتنا بعالم الطبيعة، ولن نستطيع التغيير في هذه المجالات دون استبيان فهمنا للعقلانية.
تُبرز الفجوة الجنسانية في مجال الأخلاقيات البيئية بوضوح مدى تأثير العقلانية بوصفها إطاراً أخلاقياً، ولماذا تحتاج إلى إعادة نظر. وقد توصل مشروع بحثي سويدي إلى وجود علاقة بين «الإيمان القوي بعقلانية العلوم» والتشكك بشأن تغير المناخ بين مجموعة من الرجال المؤثرين الأكبر سناً في المجال الأكاديمي، ما يشير إلى أن المشكلة تمتد لأبعد من الشخصيات المؤثرة المنتمية لليمين المتطرف، مثل تيت، ولا شك في أن عقلانية عصر التنوير كانت مصدر التحول الصناعي وظهور الحداثة، لكن على الرغم من إسهاماتها الكثيرة المهمة، فهي تمثل أيضاً إطاراً للاستبداد والظلم الشديدين.
من الثنائية والنزوع إلى الحلول التقنية إلى الإيثار الفعال ونماذج التنمية الدولية، نجد أن عالمنا يتشكل بفعل مذهب علمي نابع من فكرة مفادها أن العقلانية لا علاقة لها بالبيانات وتقدير القياسات والتحليلات وبناء المعنى المنهجي، وأن تلك الخواص مرتبطة بالعرق الأبيض والهوية الذكورية والانفصال عن الطبيعة.
هناك طرق أخرى للنظر في العقلانية، ونحن في أمسّ الحاجة إليها، فالفيلسوف الألماني يورغن هابرماس يميز بين ما يسميه «عقلانية تواصلية»، التي ترى العقلانية معتمدة على التواصل الناجح وإجماع الأطراف الفاعلة، و«عقلانية معرفية أداتية»، تمثل النوع الآلي من العقلانية الذي يتحكم في تشكيل المجتمع المعاصر.
وتزخر الأوساط النسوية بأفريقيا ما بعد الاستعمار، التي أعمل فيها، بانتقادات مهمة عديدة للعقلانية، منها مجموعة أعمال ألفتها أودري لورد، المفكرة المدافعة عن حركة النسوية، التي كتبت عن «الوعي غير الأوروبي»، الذي يكشف الواقع بصورة لا تقتصر على عقلنة الأشياء وتبريرها، وإنما من خلال الظواهر، كتلك الحسية والشاعرية.
وقد مررتُ بالأخيرة خلال فترة الإغلاق عندما كانت تباغتني كوابيس متعلقة بالمناخ، ربما كان أشدها تعلقاً بذاكرتي ما رأيته من عاصفة ثلجية ضربت شاطئاً صيفياً مشمساً، ويمكن وصف هذه الظواهر بأنها نوع من العقلانية الشاعرية المرتبطة بالبيئة التي أشارت إليها المُنظّرة السياسية ستيفاني إيريف بتعبير «استشعار الاهتزازات»، ولا شك في أن الفكر العقلاني التقليدي يستطيع تفسير تغيرات الطقس المفاجئة، لكن حينما علمتُ أن كثيرين غيري كانت تراودهم أحلام بشأن المناخ أيضاً، لم أستطع استبعاد هذه الشاعرية المرتبطة بالبيئة بوصفها أسلوباً للمعرفة، أو غير ذات صلة بالنقاش الأوسع لأزمة كوكبنا.
أودّ هنا أن أوضّح أنني لست من المؤمنين بالنسبية عندما يتعلق الأمر بالمعرفة، فلا أعتقد بتساوي كل طرق المعرفة في كل سياق، فهناك حالات تفضل فيها الموضوعية والحيادية، لا سيما عندما تتعلق المسائل بالمعرفة العلمية، لكن حينما يتعلق الأمر بالمعرفة ذاتها، ينبغي أن نتبنى وجهات نظر متعددة ونهجاً تعددياً للحد من صور التحيز المعياري، وحتى لو لم تتساوَ شتى طرق المعرفة في كل سياق، فجميعها ذات صلة.
بقدر ما أتذكر، تشكل مزاجي دوماً بالحاجة إلى التحرر من الأعراف الاجتماعية، فعندما شرعتُ في استكشاف الحركة النسوية بوصفها أداة للتحرر، كنت أنظر إلى تلك الأعراف على أنها تركيب بنيوي متراصّ يتألف من النظام الذكوري وتفوق العرق الأبيض والاستعمار الجديد، لكن سرعان ما أدركت أن هناك سجناً فكرياً أيضاً، بالمعني الحقيقي للكلمة؛ إذ يشمل ماهية معارفنا وأسبابها وطبيعتها؛ وبالتالي فإن التحرر من بنى القمع يستلزم منا أن نكافح من أجل ثورة فكرية أيضاً، بالعودة إلى مصدر المعرفة ذاتها.
في عالم يصطدم اليوم بما يطلق عليه كثيرون «أزمة متعددة الجوانب»، لا يمثل تعطيل الإطار السائد للعقلانية من خلال استخدام نهج متعدد الجوانب في التعامل مع المعرفة غاية نسوية فقط. أما الدرس الذي نتعلمه من المشاحنة بين تيت وتونبيرغ، فيتلخص في حاجة البشرية والكوكب الماسة إلى الازدهار.
* مينا سلامي، مؤسسة مدونة «MsAfropolitan» ومؤلفة كتاب «المعرفة الحسية: نهج ناشطة نسوية سوداء يناسب الجميع» (أميستاد، 2021).