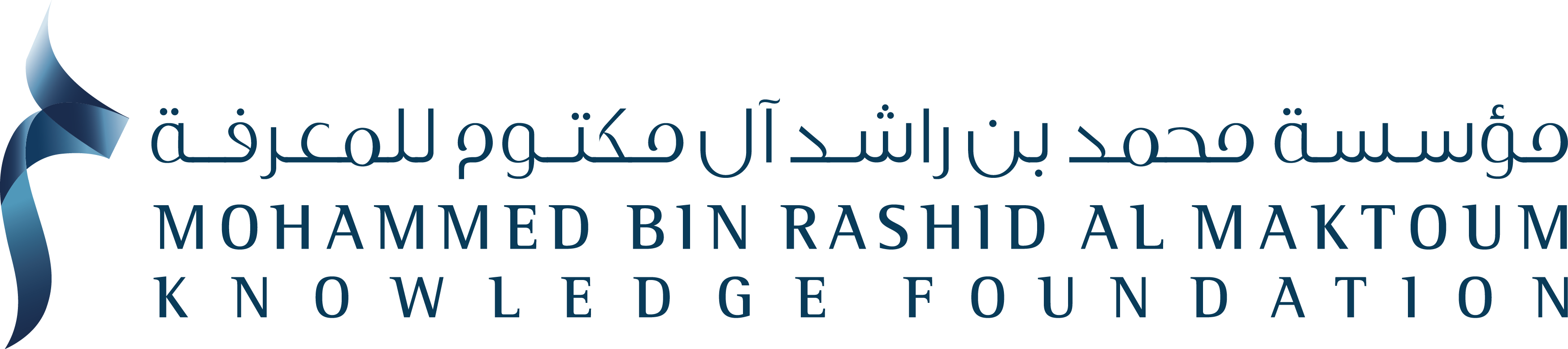دور أوروبا في حفظ السلام
كمال درويش
واشنطن - مع اقترابنا من نهاية عام 2021، يناقش الاتحاد الأوروبي خياراته وأولوياته في عالم متزايد الخطورة. لقد نجحت أوروبا منذ عام 1945 في تحقيق "مشروعها للسلام"، الأمر الذي جعل الحرب بين الخصوم القاريين القدامى أمرًا لا يمكن تصوره، ويمكن القول إنه نجح في التوصل إلى "السلام الدائم" داخل أراضي الاتحاد، حسب مفهوم الفيلسوف كانط.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أنَّ العديد من المحللين يعزون انهيار الشيوعية في الفترة ما بين عامي 1989 و1991 إلى عدم قدرة الاتحاد السوفيتي على مواصلة سباق التسلح مع الولايات المتحدة، فإنَّ نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا الغربية كان سببًا رئيسًا لفشل الكتلة السوفيتية. ولم يكن هذا أكثر وضوحًا مما كان عليه في المنافسة بين ألمانيا الغربية والشرقية.
والأهم من ذلك أنَّ ألمانيا الغربية - وأوروبا الغربية عمومًا - قد أثبتتا أنه كان من الممكن تحقيق ديمقراطية ليبرالية، واقتصاد السوق المتنامي، وسياسات تعمل على إعادة توزيع الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل فعّال. فقد أدى نجاح نموذج السلام واقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا الغربية، بقدر ضعف النظام السوفييتي، إلى الهزيمة الإيديولوجية للشيوعية وانهيارها في نهاية المطاف.
واليوم، في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها العالم، هناك "مهمتان" عالميتان يمكن لأوروبا أن تتبناهما، تماشيًا مع تاريخها بعد الحرب كمشروع لضمان السلام الإقليمي.
تتعلق المهمة الأولى بأزمة تغير المناخ. صحيح أنَّ مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو أنتج تعهدات جديدة ملحوظة من قِبل البلدان وتحالفات الجهات الفاعلة الخاصة. ومع ذلك، نظرًا إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يجب التركيز على جهود التخفيف الطموحة الرامية إلى الحد من آثار تغير المناخ في هذا العقد. يُشكّل المسار الفعلي نحو عالمٍ خالٍ من الكربون أهمية حاسمة، بدلاً من التعهدات المتعلقة بمنتصف القرن.
إنَّ الحفاظ على الاحترار العالمي قريبًا من هدف 1.5 درجة مئوية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، سيعتمد على الولايات المتحدة والصين والاقتصادات الناشئة والنامية أكثر بكثير من اعتماده على أوروبا، التي تمثّل أقل من 8٪ من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وعلى الرغم من التعهدات التي تمَّ الالتزام بها في غلاسكو والتقدم الملحوظ الذي تمَّ إحرازه في التكنولوجيات الخضراء، يُعدُّ الفوز في سباق الحفاظ على درجة حرارة العالم عند 1.5 درجة مئوية أمرًا صعب المنال.
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تلتزم إدارة الرئيس جو بايدن بجهود طموحة لتخفيف انبعاثات الكربون لكنها تواجه معارضة شديدة. إذا فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 والانتخابات الرئاسية لعام 2024، لن تكون سياسات المناخ الأمريكية كافية للوفاء بالتزامات مؤتمر قمة كوب 26، حتى لو أخذ بعض المحافظين أخيرًا مخاطر المناخ على محمل الجد.
تُمثّل الصين عقبة أخرى. إنَّ تعهدها الحالي بشأن بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 لا يتوافق مع الحاجة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. وما لم تُسارع الصين إلى الحد من انبعاثاتها الكربونية، فإننا لن نتمكّن من الفوز في سباق المناخ. ومما يزيد الطين بلة أنَّ القوتين العظميين قد تبنيان إجراءاتهما المناخية على ما تفعله القوة الأخرى.
وأخيرًا، توجد الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من الاستثمار المناخي الجديد. تعتمد قدرة هذه البلدان على المساهمة في وضع مسار عالمي متقدم لتخفيف آثار تغير المناخ على المساعدة المالية المقدمة من الاقتصادات المتقدمة. وقد وعدت الدول الغنية بتقديم مثل هذه المساعدات في جلاسكو، لكن إخفاقاتها السابقة في الوفاء بتعهدات مماثلة لا تبعث على الثقة.
هناك احتمال معقول أن يسمح مزيج من التقدم السريع في مجال التكنولوجيا الخضراء، والتطورات السياسية المواتية في الولايات المتحدة والصين، والمساعدة المالية للأسواق الناشئة بتكثيف جهود التخفيف التي يحتاج إليها الكوكب. ولكن هناك أيضًا احتمال كبير بأن تتحوّل فترة العشرينيات من القرن الحادي والعشرين إلى عقد من "الحرب الدائمة" بشأن قضايا المناخ، والتي تتسم بالتراجع وحالات التأخير والمزيد من الوعود الكاذبة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لأوروبا تأثير إيجابي على السياسات المناخية الأمريكية والصينية، لاسيما من خلال آلية تعديل حدود الكربون المنفذة بعناية والتي تفرض ضريبة على الواردات التي تستهلك الكربون بكثافة إلى الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يكون لها تأثير أكثر حسمًا في تعبئة الموارد المطلوبة للأسواق الناشئة من خلال دعم الزيادات في رأس المال للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف التي تمتلك فيها الدول الأوروبية مساهمات ضخمة.
أمّا المجال الثاني حيث قد تؤدي الظروف إلى حرب دائمة - وبالتالي تدعو إلى "مهمة سلام" أوروبية - فيتلخص في التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. وعلى الرغم من أنَّ هذه الابتكارات تُتيح للبشرية فرصًا هائلة لعيش حياة أطول ورفاهية أكبر، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر وجودية مماثلة لتلك التي تفرضها الأسلحة النووية وتغير المناخ.
ومن الصعب رسم الخط الفاصل بين الاستخدام السلمي لهذه التقنيات ونشرها لضمان التفوق الاستراتيجي على المنافسين. إنَّ التنافس التكنولوجي العدواني بين الصين والولايات المتحدة يميل بالفعل نحو صراع دائم، حيث من شأن سماح إحدى الطرفين بتقدم الطرف الآخر أن يُمكنه من السيطرة على العالم.
إنَّ ما يجعل هذا الخطر أكبر من سباق التسلح النووي في الماضي هو أنَّ تسليح التقنيات المدنية الحالية قد لا يتطلب موارد إضافية كبيرة. فقد نجحت البحوث الطبية المدنية، على سبيل المثال، في جعل العالم يقترب بشكل مخيف من القدرة على إنتاج فيروسات اصطناعية يمكن تحويلها إلى أسلحة دمار شامل. ومن المحتمل أن تظهر سيناريوهات مماثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي. والأمر الأكثر إثارة للقلق والفزع، في كلتا الحالتين، هو احتمال وقوع حوادث غير مقصودة أو إمكانية اكتساب الجهات الإرهابية غير تابعة للدول القدرة على تسليح الابتكارات.
بوسع أوروبا أن تتولى القيادة في هذا المجال، كما فعلت في مجال المناخ. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها أن تحذر باستمرار من هذه المخاطر وأن تساعد على تصميم قواعد ومعاهدات جديدة تشبه معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية التي ساعدت سابقًا على حماية العالم من حرب نووية مُدمرة. يمكنها القيام بذلك في حين تعمل على حماية القيم الديمقراطية الليبرالية الأساسية ضد إساءة استخدام هذه التكنولوجيات، ليس فقط من قِبَل الدول ولكن أيضًا من قِبَل الشركات الخاصة العملاقة.
لذلك، فيما يتعلَّق بتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة ذات الاستخدام المزدوج، يجب أن يُصبح مشروع السلام الأساسي في أوروبا عالميًّا. تتمتع أوروبا بقدرات بشرية وعلمية هائلة، وقد أدى الدمار الذي حدث في حربين عالميتين إلى تجريدها من الرغبة في الهيمنة على الدول الأخرى. وهذا يُسهل على الاتحاد الأوروبي العمل كوسيط سلام. بينما يجب على أوروبا أن تواصل بكل تأكيد تحسين رفاهية مواطنيها، فإنَّ تبني المهمات العالمية مثل تلك الموصوفة هنا من شأنه أن يوفر حافزًا جديدًا لهذه الأجيال والأجيال القادمة من الأوروبيين.
كمال درويش، وزير سابق للشؤون الاقتصادية في تركيا ومسؤول عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزميل أول في معهد بروكينغز.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org