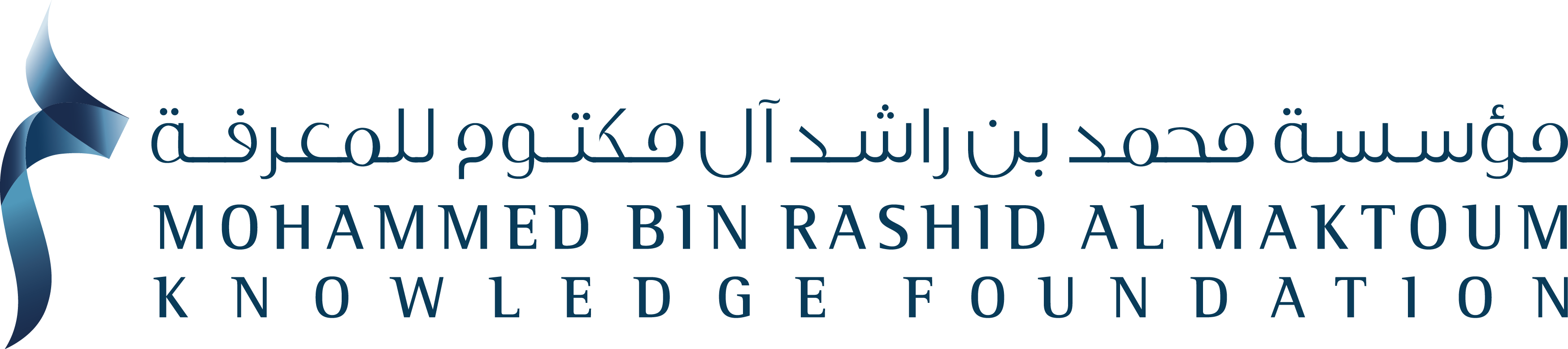تغيُّر المناخ قضية لا تقل خطورة عن الحروب
أليسيو تيرزي
يفرض تغيُّر المناخ تساؤلات محيِّرة، ليس فقط حول ما قد تدين به البلدان الغنية، التي تطلق مستويات عالية من الانبعاثات الغازية الضارة للبلدان الفقيرة الأقل نمواً، بل وأيضاً حول ما يدين به من هم في مواقع السلطة اليوم لأجيال المستقبل. كيف ينبغي لنا أن نبحر عبر المقايضات المفهومة بين التلوُّث والحق في ملاحقة أهداف التنمية الاقتصادية، أو بين المكاسب الحالية ومكاسب المستقبل؟ والأهم من ذلك أيُّ أنظمة الحكم أنسب لمواجهة هذا التحدي؟
من منظور أولئك الذين يريدون أن يروا استجابة أقوى كثيراً لتغيُّر المناخ، من السهل إحصاء كل الطرق، التي قصرت بها الديمقراطية في الوفاء بوعدها. لنتأمل على سبيل المثال حال الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر مصادر انبعاثات غازات الانحباس الحراري الكوكبي في التاريخ. وفقاً لتقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث في يونيو 2020، يقول ثلثا الأمريكيين إنهم قلقون بشأن تغيُّر المناخ ويودون لو تبذل الحكومة الفيدرالية المزيد من الجهد لمعالجة هذه المشكلة، وفي وقت لاحق من ذلك العام انتخب الشعب الأمريكي رئيساً ديمقراطياً يَعِـدُ ببرنامج قوي فيما يتصل بسياسة المناخ، ولكن بسبب مقاومة عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ من ذوي الميول المحافظة استغرق الأمر عاماً ونصف العام من المفاوضات الـمـنهـكة، لتقديم أي تشريع يتعلَّق بالمناخ على الإطلاق، وقد تتعرَّض بعض هذه المكاسب للخطر قريباً إذا عانى الديمقراطيون من ذوي الوعي المناخي من خسائر جسيمة في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.
علاوة على ذلك، في حكمها الصادر في قضية وست فيرجينيا ضد هيئة حماية البيئة في وقت سابق من هذا العام، قيدت الأغلبية العظمى المحافظة في المحكمة العليا سلطة الفرع التنفيذي في صنع السياسات المناخية. الأسوأ من هذا أنَّ نظام الحكم اللامركزي في أمريكا يعني أنه حتى في حال الموافقة على الاستثمارات الخضراء على المستوى الفيدرالي، يظل من الممكن إخراجها عن مسارها على مستوى الولايات. وفي مواجهة المعارضة الصريحة للمشاريع الجديدة ــ سواء مزارع الرياح أو مواقع التنقيب عن المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائيةــ سيستسلم المسؤولون على مستوى الولايات أو المدن غالباً لشعار «ليس في الفناء المنزلي الخلفي«.
على النقيض من ذلك، في حين تحرز أمريكا تقدماً ضعيفاً أثبتت الصين قدرتها على زيادة سعة توليد طاقة الرياح البحرية في غضون عام واحد بمقدار أكبر مما حققته أيُّ دولة أخرى في غضون خمس سنوات. ونظراً للخطوات الهائلة، التي قطعتها في نشر البنية الأساسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، أصبحت الصين على الطريق لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة لعام 2030 قبل خمس سنوات من الموعد المحدد، ومن خلال مواجهة المعارضة المحلية لعمليات الاستخراج شديدة التلويث، تستطيع الصين أن تثبت نفسها أيضاً رائدة عالمية في مجال استخراج المعادن الأرضية النادرة، التي تشكِّل ضرورة أساسية للكهربة والتحوُّل الأخضر في عموم الأمر.
نظراً لمثل هذه التناقضات، ربما لا يكون من المستغرب أن تفقد الديمقراطية حظوتها بين المواطنين في مختلف أنحاء العالم. هذه هي الحال بشكل خاص بين المنتمين إلى جيل الألفية الواعين مناخياً وأبناء الجيل زد (جيل الإنترنت)، الذين ينظرون إلى الديمقراطية على نحو متزايد باعتبارها عاجزة عن تسليم الحلول لأزمة المناخ، وكما حذَّر أليكسيس دي توكفيل في كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، «يقدم الطرف الآخر نفسه غالباً على أنه الـمـصـلح لجميع العلل التي يعاني منها البشر، والداعم للحقوق العادلة، والمدافع عن المظلومين، والـمـنشـئ للنظام»، لكن الشباب لا يشعرون بخيبة الأمل إزاء افتقار الديمقراطية الواضح للقدرة على الاستجابة فحسب، بل يستسلمون لإغواء الحجج المستندة إلى القيم الأخلاقية لصالح «الاستبدادية البيئية»، التي ينظر إليها كثيرون على أنها شكل أرقى من أشكال الحكم في عصر تغير المناخ.
وعلى هذا فقد زعم عالم الأرض الشهير جيمس لوفلوك في عام 2010 أنَّ «أفضل الديمقراطيات تتفق على أنَّ الديمقراطية يجب أن تحال إلى وضع الانتظار في حال اقتراب حرب كبرى، ويخالجني شعور قوي بأنَّ تغيُّر المناخ قد يكون قضية لا تقل خطورة عن الحرب، وقد يكون من الضروري تعليق الديمقراطية لبعض الوقت»، ثمَّ اكتسبت الحجة لصالح الاستبدادية البيئية المزيد من القوة منذ اندلاع جائحة (كوفيد 19)، التي دفعت العديد من الديمقراطيات الليبرالية إلى إعلان حالة الطوارئ، وتعليق بعض الحريات الأساسية، وخاصة قدرة المواطنين على التنقل والتجمع بحرية.
وفي العديد من البلدان، وخاصة في المرحلة المبكرة من الجائحة، جرى تقسيم الوظائف بين «أساسية» و«غير أساسية»، مع السماح للمنتمين إلى الفئة الأولى بمواصلة العمل، في حين اضطر المنتمون إلى الفئة الثانية إلى التوقُّف الفوري. يودُّ أنصار الاستبدادية البيئية لو يرون مثل هذا التخطيط المركزي موضع التنفيذ للتمييز بين الأنشطة الـمـلـوثة وغير الـمـلـوثة.
علاوة على ذلك، حتى في الولايات المتحدة ــ الدولة الرأسمالية بامتياز ــ استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون الإنتاج الدفاعي الصادر عام 1950 لتسريع إنتاج اللقاح، ليتهرب فعلياً من الالتزام الصارم بمبادئ الملكية الخاصة، وحرية إقامة المشاريع، والنتائج المحددة من قـبـل السوق ــ وجميعها أمور تصبُّ في المصلحة المشتركة للبلد. لماذا لا نفعل ذات الشيء في إدارة الانتقال إلى اقتصاد الصـفر الصافي؟ قد يحدث هذا، فقد أعلن البرلمان الأوروبي، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية بالفعل حالة الطوارئ المناخية، وقبل الاختراق التشريعي هذا الصيف، كان بايدن تحت الضغط لحمله على فعل ذات الشيء.
مثلها كمثل المناقشات الاقتصادية الكبرى الأخرى الدائرة في أيامنا هذه، تحمل هذه المناقشة نكهة سبعينيات القرن العشرين، إضافة إلى ارتفاعات أسعار النفط والركود التضخمي، انطلقت الحركة البيئية الحديثة بكامل طاقتها، فبعد كتاب راشيل كارسون الصادر في عام 1962 بعنوان «الربيع الصامت»، نجحت مطبوعات انتشرت على نطاق واسع مثل «القنبلة السكانية» للكاتب بول إرليش عام 1968، وتقرير «حدود النمو» الصادر عن نادي روما في عام 1972 (الذي أصدر إنذاراً مبكراً للغاية بشأن الطبيعة المحدودة، التي تتسم بها الموارد على كوكب الأرض) في إقناع عدد كبير من الناس بأنَّ مسار المجتمع الحديث يستلزم إنشاء نظام قادر على إجبار الناس على العيش المستدام.
* مـحاضـر في معهد العلوم السياسية في باريس، هو خبير اقتصادي لدى المفوضية الأوروبية .